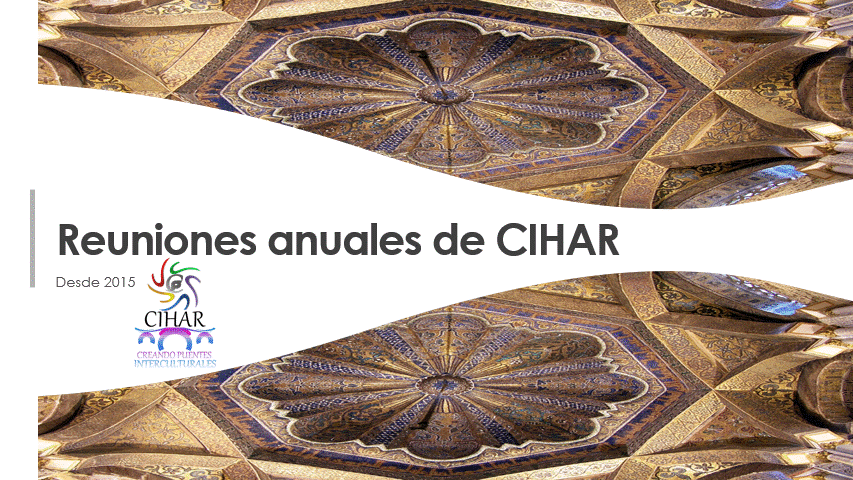اللغة العربية هويّة ووحدة ووِصال
محمد نجيب عبد الكافي

ولد في 16 يونيو 1928 في تونس، وهو كاتب وصحفي ومترجم ومعلم وفلكلوري مقيم في إسبانيا منذ سنوات عديدة. وتولى، بصفته مراسلا لعدد من وسائل الإعلام العربية، رئاسة نادي الصحافة الدولي الإسباني. وتشمل منشوراته أعمالا باللغة العربية بين قلبين (بيروت، 1966)؛ عميد المُستعربين الإسباني، بيدرو مارتينيز مونتافيز (2016) وإسبانيا، من الديكتاتورية إلى الديمقراطية (1991). باللغة الإسبانية وقد نشر العرب، لماذا؟ (1991) والمجلد الأول من الحكايات الشعبية التونسية (2010، الذي ظهر أيضا باللغة العربية في تونس في عام 2012. وفي هذا البلد نفسه، نشرت ترجمته للعربية الابتسامة الأترورية، من تأليف خوسيه لويس سامبيدرو (1985)، مع طبعة ثانية في القاهرة في عام 2009. كما كتب مقالات عن ليبيا، وأقوال، وما إلى ذلك، «والبحث عن طائر الزمرد وحكايات تونسية أخرى لليلى عُلا» حكايات تونسية
مُحاضرتي للمشاركة في انشطة المُنتدى الثقافي العربي الإسباني (ثيــار) بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية، ضمن «2021، عام اللغة العربية» المُعلن منه في إسبانيا
أوقعني الحدث في شباك اللغة. وأيّة لغة؟ لغة الضّاد، لغة القرآن. ومتى جاء التحدث عنها؟ يوم عيدها العالمي. عيد اللغة التي قال عنها العالِم الهولنديّ الشّهير فارغوسونFerguson، ذلك المفكر والمؤرّخ الذي يتقن ستَّ أو سبعَ لغات: ¨إن اللغة العربيّة اليوم، سواء لعدد متحدثيها، أو لمدى تأثيرها في غيرها من لغات العالم، فإنها تعدّ من أعظم اللغات السّامية، وينبغي أن يُنظر إليها على أنها إحدى اللغات العظمى في العالم.» عيد اللغة التي قال عنها أو نطق بلسانها، شاعر النيل والعروبة، الفصيح المبدع، حافظ إبراهيم فجعلها تقول:
وسَعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقــت عن آي به وعــظات
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمختــرعـات
أنا البحر في أحشائه الدرّ كامن فهل سألوا الغوّاص عن صدفاتي
سألنا يا سيدتي البليغة، سألنا فجاءتنا الأجوبة كثيرةٌ متعددّة، وما وجدناه من صدفاتك الثمينة، فاق تصّورنا وأعجز إدراكنا، فما غنمنا من بحرك إلا القليل، وما فقهنا منه سوى ما استطاعت عقولنا القاصرة، وذاكرتنا المحدودة أن تستوعبه وتهضمه. لقد جئت يا سيدتي أن أتحدث عنك في يومك العالمي هذا، فكيف لي بذلك وأنت البحر الذي لا يُسبر غوره. فهل أعالج ماضيك المجيد، أم حاضرَك المُذبذب المهتز، أم مستقبلك الغامضَ المهدد؟ كل ذلك عليّ عسير لكن أستسمحك، وأنا الضعيف القاصر، أن أحاول، فأجرُأ على نقل أو تقديم أو شرح شعاع من أشعتك الوضّاءة.

تعريـف: لكن، قبل الغوص في متاهاتك، دعيني أسال أو أتساءل ما هي اللّغة؟ إنها حسب المفهوم العام نهج أي طريقة لسانية تتميّز بأنها محدّدة ومعنيّة كلّيّة لامتلاكها درجة عليا من التجربة والمعادلة، لأنها حاملة ثقافة مختلفة، وفي بعض الحالات لأنها فرضت على طرق لسانية أخرى. إنها في نظر ويلمر زامبرانو كاسترو «اساسُ بناءِ وتعبيرِ ثقافةِ مستعمليها. فالهويّة التي يصنعها هؤلاء أنفسهم، مرتبطة وثيق الارتباط بالكلمة التي يستطيعون التفوّه بها ضمن هذه «الشفرة الخاصّة». فاللغة التي نستعملها، هي في نهاية الأمر، التي تمنحنا رؤيانا الخاصّة عن العالم، تلك الرّؤيا التي نعبّر عنها فتميّزنا.» إذا تمعّنا وتبصّرنا في هذا التعريف، وجدنا أن اللغة بالنسبة لشعب من الشعوب، هي بمثابة الجينة، أي عنصر الوراثة، لدى الفرد الواحد. هي الوسيلة الرّئيسية للاتصال والتواصل والتخاطب. إنها تسمح بأفضل التفسير لما يُراد أن يٌعرف، وأفضلِ فهم لما تُرغب معرفته أو التعرّف عليه. إنها، بالنسبة لشعب ما، الأداة الضّرورية للتعبير عن مشاعره، ورؤاه للعالم، ومعتقداته، وثقافته. سواء أكانت شفوية أو حركيّة إشاريّة أو مكتوبة، فهي تعطي الشعب أفضل وسيلة للتعريف بهويّته، وإبراز مخالفته أو عدم شبهه والآخرين. قد تجدر الملاحظة هنا، أن الأمر لا يتعلّق بتنظيم المفردات وتنسيقها، أو احترام قواعد النّحو والصّرف، لتُسدل عليها صفة الهوية، إنما هو الفنّ الذي يُعبّر به، فيرنّ فيأخذ بلباب المخاطب ويسحره، وهذا ما يجعل اللغة وديعَ تقاليدِ مجتمعٍ ما.
الـهـويّـة: نلاحظ في هذا التعريف المقتضبالموجز، أن اللغة تميّز ناطقيها ومستعمليها عن غيرهم، ثم هي حاملة لثقافتهم ومعتقداتهم ورؤاهم، وهي أيضا وسيلة اتصالهم فيما بينهم وبغيرهم. لو اضفنا القول الكريم الذي يقول: خاطب الناس بما يفهمون وعملنا بالمقولة التي مفهومها: من تعلّم لغة قوم أمن شرّهم، وجدنا أن اللغة هي كذلك وسيلة إبلاغ ودرع وقاية. هكذا تصبح اللغة هويةً وأداةَ اتصال ودرعَ وقاية وعاملَ وحدة تربط، وثيق الرّباط، بين مستعمليها، وهذا ما أدّى بالقسّ «زويمر» Zeumer في مستهل القرن العشرين (1906) أن ينادي بالقضاء على اللغة العربية، لأنها توحّد بين المسلمين. أما من نادى بطمسها من أبنائها، فكلّ له غايته ومرماه. فعبد العزيز فهمي نادى في مستهل الأربعينات (1943) بتغيير الحروف العربية وكتابتها بالأحرف اللاتينية. أمّا سلامة موسى فقد أيّد اقتراح » ولكوكس » بجعل اللهجة المصرية لغة كتابة ومن ثمّ إهمال اللغة الأم. لكن، بعد طرح هذه التهجّمات ومحاولات الطّمس والقضاء جانبا، هل اللغة العربية تحمل كلّ هذه المعاني التي أوردناها؟ إنها فعلا تحملها، وتحمل أكثر منها قولا وفعلا، لأنها أثبتت ذلك عبر التجربة والتاريخ، فكانت لسان شعوب شتّى، ومرآة ثقافات متعدّدة، واساس حضارة ومدنية سادت ولمعت، ولا تزال آثارها حيّة ملموسة.
هنا لا باس من وقفة قصيرة، وطرح سؤال بسيط في مظهره، وقد يكون معقّدا في أصله، لأن الملاحظ، عبر التاريخ والعصور، أنه إذا سادت مدنية أو حضارة، سادت لغة قومها أو بعكس ذلك، إذا سادت لغة قوم، سادت حضارتهم. فهنا يأتي السؤال، وهو شبيه بذلك المتعلق بالدجاجة والبيضة، فمن أتى بمن؟ من السابق ومن اللاحق؟ هل الحضارة تقوم على اللغة، أم اللغة تقوم على الحضارة. إن المؤكد هو أن الشعوب التي بنت حضارة أو مدنية ما، كانت لها لغتها قبل انتشار وسيادة حضارتها. مهما يكن من أمر، فاللغة تلعب أكبر دور في قيام، ونشر، وتثبيت، أيّة مدنية، وقد تنحدر أو تندثر المدنية، دون أن تزول اللغة الباقية ما بقيت شعوب تستعملها. إن استعمال أي لغة لا يتوقف أو ينحصر في ترتيب المفردات، وتطبيق قواعد النحو والصّرف، كما أسلفنا، بل هو نسق وطريقة وأسلوب، بل اساليب، ترمي جميعها إلى إبراز ما بالفكر والباطن لشرحه أو لإبلاغه، أو لنقله، أو للتعريف أو التعبير عن مشاعر وأحاسيس. فبالنسبة للغتنا العربية، والناطقين بها من أبنائها، نجد أن الكثيرين منهم يستعملون تلقائيا في كلامهم، مقولات وأمثالا وتشبيهات واستعارات، كي يعبّروا تعبيرا أفضل عن مشاعرهم، وبث أفكارهم وآرائهم، ومن ثَمّ يثبّتون مواقعهم ومواقفهم، أو معارضاتَهم دون عنف، وقد يكون ذلك تحاشيا جرح مشاعر مخاطَبيهم. فهذه المعدات اللغوية أو الأدوات هي، في نظر بعضهم، عربون سِلم اجتماعيّ، وقد تكون أيضا علامة رقة، أو هي دلالة على التفخيم في بعض الحالات. فهذا لعمري من مكوّنات الهوية. إنّ اللغة، هي ايضا، دعامة ميراث الشعوب، إذ هي تُنقل أو تسلّم من جيل إلى جيل بطريقة طبيعيّة. إنها عماد الثقافة وهي ايضا صلتنا بالماضي، إذ هي الخيط الرابط بذلك الماضي. بهذا الخصوص يقول العالم المالي «سيدو بَدْيان كوياتي»: “باللغة نعرف ما ترك لنا الماضي من رسائل وما يصنّفه وينظمه الحاضر لنا. إن اللغة هي التي تربطنا وهي التي تؤسس هويتنا. لكل هذا، يمكن التأكيد بأن الشعب الذي يفقد لغته لفائدة شعب آخر، هو شعب ضائع خسر جزءا هاما من هويته. «
إن الحلّ الوحيد، حسب رأينا المتواضع، للمحافظة على الهوية والأصالة بالانتساب إلى مدنية وحضارة وتاريخ وثقافة بعينها، هو التصالح مع النفس والعمل على اتساع القيم الخاصة بإحياء اللغة وتطويرها، لا مسخها.
خصائص وميزات: إن لكل لغة مميزاتها وخصائصها التي كثيرا ما اختلفت، وأحيانا تشابهت، مع خصائص لغة أخرى، لكنها تبقى منفردة بمجموع ما تختصّ به من صفات وقواعد وميزات. أما اللغة العربية فهي المتمتعة بأكبر عدد من المميزات، التي قد يطول شرحها، إذا حاولنا التعرّض الى جميعها فندخل، إن فعلنا، في اختصاص هو بعيد عن غايتنا من هذه العجالة. لذا سنبرز أهمّ خصائص لغتنا فنقول:
يقول الأستاذ عبد الرحمن الكيالي في عمله القيم المفيد «عوامل تطور اللغة العربية وانتشارِها “: تمتاز اللغة العربية عن سائر أخواتها اللغات السامية وعن سائر لغات البشر، بوفرة كلماتها، حتّى قال السّيوطي في «المزهر» أن المستعمل والمهجور منها يبلغ عدده 78.031.312 والزبيدي يقول في تاج العروس إن الصّحيح يبلغ 6.620.000 والمعتل يبلغ 6000 كلمة.
إنّ هذه المفردات مع وفرتها، هي أداة اطّراد في قياس أبنيتها، تمتاز بتنوّع أساليبها وعذوبة منطقها، ووضوح مخارجها، ووجود الاشتقاق في كلماتها. فمن خصائصها وميزاتها، أنها أوسعُ ثروةً في اصول الكلمات والمفردات من أخواتها السامية. يروي لنا الفايروز بادي صاحب القاموس، أن للسيف في العربية ألف اسم على الأقل ويقدر آخرون أن للداهية 400 اسم، ولكلٍّ من المطر والريح والظلام والناقة والحجر والماء والبئر، أسماء تبلغ العشرين في بعضها، و300 في البعض الآخر.

نستخلص من كلّ ما سبق، أنّ طريقة توليد الألفاظ بعضِها من بعض، تجعل من اللغة، حسب قول الأستاذ الأزهري أحمد عبد الرحيم السائح، «جسما حيّا تتوالد أجزاؤه، ويتصل بعضها ببعض بأواصرَ قويةٍ واضحة، تغني عن عدد ضخم من المفردات المفككة المنعزلةِ التي كان لابدّ منها، لو عُدِم الانشقاق. فلا غرابة إذن أن نرى اللغة العربية، في ظلّ الحضارة الإسلامية، قد اصبحت ابعد اللغات مدًى وأوسعَها أفقا، وأقدرها على النّهوض بتبعاتها الحضارية، عبر التطور الدائم الذي تعيشه الإنسانية. واستطاعت اللغة العربية في رحاب عالمية الإسلام، أن تتسع لتحيط بأبعد انطلاقات الفكر، وترتفع حتى تصعد أرقى اختلاجات النفس، وقد زادتها مرونتها وقدّرتها على التفوق، تبلورا وتفاعلا ونماء، وأعطتها طاقة خلاقة وحياة مدهشة.»
امتداد العربية في اللغات الأوربية: لو منحنا الله السلطان الذي تحدث عنه في كتابه العزيز، واستطعنا أن ننفذ من أقطار . السماوات، فتجولنا بين الأقمار والكواكب والنجوم:
منتقلين من الشّولة (shaula) الى الشّعرى (sirius) ومنها الى العقدة (okda) مروراً بالعقرب (akrab) والعذارى (adhara) والعنقاء (ankaa) والقائد (alcaid) والنطاق (alnitak)
لقضينا العمر بينها ووجدنا، بشهادة جمعية الفلك العالمية ، أكثر من نصف تلك الأجرام عربية الاسم، وذلك نتيجة الفكر العربي الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. فلا غرابة إذن، إذا ما سادت حضارة فسادت لغتها، أن يكون لهذه الأخيرة أثر وبصمات في كلّ ما اتصل بتلك اللغة وحضارتها. فلغتنا العربية، التي نشأت في شبه الجزيرة مقصورة على أهلها، نراها انتشرت انتشارا واسعا، نتيجة الفتوحات ثم ازدهار المدنية العربية الإسلامية، فأصبحت اللغة الدينية في آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا الشمالية، وفي أوربا أيضا، خاصّة في قبرص والجزيرة الكريتية وشبه الجزيرة الإيبيرية ومالطة وصقلية. فهذه اللغة التي كانت موقوفة على العرب، انتشرت في القرون الوسطى في عدّة قارات واتسعت، اجتماعيا، فضمّت شعوبا غير عربية، وهي اليوم لغة رسمية في عدد من المنظمات الدُّولية.

إن بواعث الإشعاع الثقافي، الذي جعل ويجعل من اللغة العربية وسيلةَ تعبير في عديد القارات والبلدان، يمكن حصرها في ثلاثة بواعث، هي الدين الإسلامي والأدب الشعري والنثري، وفي أيامنا هذه وسائل الاتصال والإعلام المعاصرة. لذا نجد لغات وشعوبا كثيرة انطبعت وتنطبع، بدراجات متفاوتة الأهمية، باللغة العربية، كالبرتغالية على سبيل المثال، حتى أنّ بعضها كتب بالأحرف العربية، مثل اللغة الأندلسية المسماة بالمدجّن، والتي استوعبتها اللغة القشتالية ابتداء من عام 1240، وهي الى اليوم لا تزال تلك البصمات العربية من أبرز مكوناتها. ثم إن تأثير اللغة العربية واضح حيث كان التأثير الشامل من الحضارة الإسلامية، كما هو الشأن بالنسبة للممالك الجليقية. نجد أيضا أن لغة صقلية والجنوب إيطالية خاصة، متأثرة، لكن بأقل درجة، بالفترة العربية ولغتها، وذلك بين القرن التاسع والقرن الحادي عشر. فلا غرابة إذن أن نجد معظم اللغات الأوربية ثرية، بتفاوت بين لغة وأخرى، بالمفردات العربية المأخوذة رأسا، أو عن طريق لغة أوربية أخرى، كالإسبانية أو الإيطالية، والحفاظ على المفردة سليمة طبق أصلها، أو مكيفة محرّفة – وهو الأغلب – حسب مقتضيات وطريقة نطق أهل اللغة المستقبلة. كمثال لتجسيم ذلك نأخذ اسم الزرافة فهي بالإيطالية » جيرافا » وبالفرنسية » جيراف » وبالإسبانية » خيرافا «. فالتحريف، كما هو واضح، خفيف جدا. لكن من يستطيع التكهّن أو الإثبات بأن كلمة » فراكسيون » بالفرنسية أصلها عربي وهو كلمة قصر؟
بعد هذا العرض الموجز المقتضب نستطيع القول بأن اللغة العربية ناقلة وخلاقة. فقد نقلت علميا من اليونانية والسُّريانيّة والفارسية وبعض التراث البابلي، ثم هي خلاقة ودورها في الخلق عظيم، غير أنه لم يقدّر حقّ قدره، خاصّة فيما يتعلق بالتجديدات والمحدثات التي اتت بها الحضارة العربية الإسلامية الى المدنية العالمية. لقد أشرنا قبل حين إلى أنه من مجموع مائتي اسم من اسماء الكواكب والنجوم نجد النصف ناشئا عن الفكر العربي، فهو من خلق الخيال العربي المحض. ثم إن الرياضيين، أكثر من غيرهم، يجسّمون دور المدنية الاسلامية واللغة العربية في هذا النسق الناقل الخلاق، فنرى أن العرب نقلوا الأرقام الهندية التي تسمّى اليوم عربية، كما نقلوا الصّفر واستعملوه، فكانوا، بفضل الفلكي الرياضي العظيم الخوارزمي، سباقين في استعماله وتطبيق نظامه. ثمّ جاء الإيطالي» فيبوناتشي الذي أدخل الأرقام العربية في شكلها الحالي عام 1202، آتيا بها من بجاية بالجزائر، فنشرها في كتاب حساب ومحاسبة قائمين على النظام العشري، وذلك في فترة كان فيها الغرب لا يزال يستعمل الأرقام الرومانية. غير أن مجهوده قد لاقى رفضا وسمّي «شيفرا» أي صفر الذي أصبح » زيرو» ومنه أخذت ايضا مفردة «شيفر» أو شفرة.

بإسبانيا : لقد سادت اللغة العربية ، كما أوجزنا ، في كامل حوض البحر الأبيض المتوسط وبلدانه ، أما في اسبانيا حيث استقرت ثمانية قرون ، فقد كوّنت لها مرتعا أشعّت فيه إشعاعا مدهشا، عبر نهضة وحضارة، وهو ما عُرف بالأندلس ورُقيّه وسبقه الحضاري، الأندلس الذي قال عنه المفكر، شيخ المستعربين الإسبان الدكتور بيدرو مارتيناث مونتابث في كتابه القيم الشامل «مدلول ورمز الأندلس»، أن «مضى زمنيا لكنه حاضر باق بالذاكرة الجماعية «، وينقل لنا عن الفرنسي بيار فيلار قوله: لقد عرَفتْ القرون الوسطى اسلاما اسبانيا مليئا حياة وابتكارا ، فمهّد ثراؤه وفكره وتعقيداته ، ما هو ليس دون الاسترجاع المسيحي ، الانجازات العظمى لإسبانيا المستقبلية ، ويردفه بشهادة المؤرخ القطلاني فيسانس بيبس القائل أن » الأندلس كان بلا منازع أقوى دولة في أوربا» ثم يضيف ما جاء به الإناسي خوزسه أنطونيو خاوراغي هو: إن ما ندين به نحن الأوربيون للعرب المسلمين عظيم ومجهول: علينا نحن الأوربيون أن نعرف ، وما هو أهمّ ، أن نعترف بهذا الدَّيْن الثقافي الضّخم . والدَّين الثقافي بخلاف الاقتصادي لا يمكن تسديده بالمال.» أما خوسي لويس أرانغوران فهو يرى أنه من » العدل الاعتراف بأن العرب ساهموا ايضا، وبنصيب بارز، في تطوّر ما نسميه ثقافة غربية وخاصّة منها الإسبانية.»
كل هذا العطاء، أساسه وأداته اللغة، التي أشعت في المجتمع الإسباني اقتصاديا وفنيا وادبيا، فلا غرابة بأن تترك بصماتها في اللغة الإسبانية. فإذا تمعنا في اللغة الإسبانية وجدنا هنا رنّة خاصّة، وهناك نوعا من الأداء الصوتي الشرقي، ووجدنا أيضا محتوى مثيرا مُحياً، فتتميز اللغة الإسبانية بذلك عن اللغات الأوربية الأخرى، علاوة على ما احتوته من عبارات وكلمات ومفردات عربية، منها ما هو باق على أصله، ومنها ما حُرّف، ومنها ما تكيّف نطقا ومعنى. إن تأثير اللغة العربية الكبير على اللغة الإسبانية، قد دفع ببعضهم الى محاولة تخليصها منها، كما فعل رجال دين كانوا مترجمين بمحاكم التفتيش بغرناطة، منهم الأب فرانثسكو رويث تاماريد الذي ألف قاموسا بالمفردات التي أخذتها لغته عن العربية. رغم هذا، ورغم تطور اللغة الإسبانية، فإن الأخصائيين يقدّرون ما بها من مفردات عربية يمثل 8% فيعطينا هذا حوالي 4000 مفردة، بما فيها ما هو قليل الاستعمال. ويعتقد الكثيرون بهذا الصّدد، أنّ كل الكلمات التي بدايتها أل هي عربية الأصل، وهذا لعمري خطأ. فكثير من المفردات الإسبانية تبدأ بأل وهي بعيدة عن العروبة، بينما هي كثيرة تلك التي بدياتها أي حرف من حروف الهجاء وهي عربية قحّة.
مثال ذلك: خاكيكا (jaqueca) الشّقيقة، ريهان (rehén) رهان ورهينة، طاهونة (tahona) طاحونة، بدانا (badana) بطانة، كنديل (candil) قنديل، كركاخادا (carcajada) قهقهة
والقائمة، كما يعلم الجميع طويلة وطويلة جدّا. إن اللغة العربية كانت، كما سبق القول، أداة تحضّر وتمدّن ونتيجة لذلك فهي لم تقتصر على ترك مفرداتها في هذه اللغة أو تلك، بل هي في إسبانيا قد تركت ما نستطيع أن نضمّه الى الأخلاقيات والتصرّفات الحياتيّة. كمثال بسيط للدلالة على ذلك نقول: لو استضافك إنكليزي مثلا، استقبلك بباب بيته وحياك وقال لك أدخل، وإذا دعت الحاجة فال: استرح. وإذا كان المضيف فرنسيا أو إيطاليا كان تصرّفه مشابها لكن معه مجاملة وهي: تصرّف كما لو كنت في بيتك أما الإسباني فهو يقول لك أهلا فيُدخلك ثمّ يقول لك امتلك يا سيدي بيتك ويتجوّل بك في كلّ أركان البيت كأنك مشتريه. أليس هذا صورة من عبارتنا المختصرة: البيت بيتك. ثمّ إن العرب اعتادوا في أحاديثهم وتحاورهم أن يؤكدوا النفي أو الإيجاب بقولهم لا يا رجل، بلى يا امرأة ، كلا يا بني وإخواننا المشارقة محتفظون بذلك الى يومنا هذا، والإسبان أيضا إذ لغتهم هي الوحيدة في الغرب التي تتبع تلك الطريقة فنجد ظاهرة أخرى تتعلق بالمرأة التي ضمن لها الإسلام الحفاظ على شخصيتها مستقلة عن أيّة تبعيّة ، حتى أنها إذا تزوجت بقيت السيدة كذا ابنة فلان لا كما هو الشأن في الغرب حيث تفقد الزوجة لقبها فتنسب إلى لقب الزوج ، طريقة متبعة، بكل اسف ، في الكثير من بلداننا العربية الإسلامية
مهما كانت النسبة، ومهما كانت التصرفات من جانب أو آخر، فإن التلاقح، كالتلقيح بالنسبة للأشجار المثمرة، هو ثراء ونماء ووسيلة تقارب وتفاهم، تسهل التعايش والتعاون والتعاضد والتآزر. فالعلاقة العربية الإسبانية غير موقوفة على اللغة، بل هي أواصر متعدّدة متنوعة، فالأمر إذن كما قال الدكتور مارتيناث مونتابث في مؤلفه الثري الذي أشرنا إليه سالفا » لا يكلفنا كثيرا إذن، الاعتراف بأن بين العرب والإسبان، هناك نوع من » الهواء العائلي»، وبصفته العائلية بالذات، ولكونه هواء، يستطيع أحيانا أن يداعب كنسمة خفيفة، كنسيم لطيف، وأحيانا أخرى يعصف مهدّدا وعنيفا كالريح الهوجاء. لكنّي، أصرّ على أنها مسألة عائلية … » واسمحوا لي أن اضيف على كلام الدكتور مارتيناث فأقول: بما أنّ الأمر عائلي، فبين أفراد العائلة الواحدة لابدّ بل من الضّروري أن يسود الوئام والتضامن.

فاللغة العربية، بعد هذا العرض المقتضب الفاقد للنظام والترتيب الأكاديمي، هي – حسب وصف الأستاذ أحمد فارس، صاحب الجوانب، بين اللغات » أوسعها وأسنعها، وأخلصها وأنصعها، وأشرفها وأفضلها، وآصلها وأكملها، وذلك لغزارة موادها، واطّراد اشتقاقها، وسرارة جوادّها، واتحاد انتساقها، ومن جملته تعدّد المترادف، الذي هو للبليغ خير رافد ورادف، وما يأتي على رويّ واحد في القصائد، وهو ما يكسب النظم من التحسين وجوها، لا نجد لها في غيرها من لغات العجم شيئا.» فهذه اللغة هي أساس بناء، وتعبير ثقافة قوم، استعملوها وهم نحن العرب. والهوية التي نصنعها لأنفسنا – حسب الأخصائيين – مرتبطة وثيق الارتباط بالكلمة التي نتفوّه بها ضمن هذه الشفرة الخاصّة. فاللغة التي نستعملها هي التي تمنحنا، في نهاية الأمر، رؤانا الخاصّة عن العالم، تلك الرّؤى التي نعبّر عنها فتميّزنا. وهي التي تمثّل أو تثبّت هويتنا، أي ذلك الشعور بالانتماء إلى مجموعة بشريّة معيّنة، تلعب اللغة فيه دورا أساسيا، إذ هي الوحدة التي تحدّد وتساعد فينا، الشعور بوجود أنواع لسانية خاصة، ومميزة لمجموعتنا، التي تميزنا بدورها عن غيرنا حتى نستطيع، حسب اللساني فلمر زامبرانو كاسترو يقول مثلا، » التفكيرَ في أن الهوية كانت أحد العوامل الحاسمة في ظهور مختلف اللغات، وضمنها مختلف اللهجات والتعابير». لغتنا هذه بَنَتْ حضارة إنسانية خلاقة، فكانت عامل إشعاع لقيم ومبادئ، علاوة على مخترعات فكرية ومادية، كانت الإنسانية، ولا تزال، تحتاجها لحياتها بالمفهوم السّامي. وحّدت هذه اللغة، وتوحّد وستضل توحّد بين ابنائها والناطقين بها، لأنها عامل وصل واتصال، وحاملة ثروة فكرية لا ينضب معينها. وأخيراً، لا آخراً، فاللغة العربية لغة متفتحة قابلة، فهي إذن لغة التواصل، ومن ثَمَّ لغة التفاهم والتعاون والتضامن، وهذا يعني أنها لغة إنسانية أو بالأحرى لغة الإنسانية.
قائمة انباء